طوال الخمس أعوام الماضية، كنت أشارككم في مثل هذا اليوم، تدوينة عيد ميلادي معنونة بعنوان يصف العام الذي عشته. (أُحب المشي… معِك) هذا هو عنوان عامي الذي انتهى بالأمس، والذي اخترته قبل عدّة أيام في لحظة مشي طويلة، استعدت بها كل الخطوات التي مشيتها طوال العام، بل وتاريخي الشعوري حيال المشي.
لم ولن يكن المشي طقساً روتينياً أتنقل به من مكان لأخر! (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) 20، سورة العنكبوت. بهذا المشي سرت نحو نفسي فاكتشفت إلى أي حدّ أُحب المشي معي!

كان المشي طوال حياتي وسيلتي في توطيد علاقتي مع كل من أُحِب وأحببت. مع الموسيقى التي أسمع، والقهوة التي أشرب، مع السماء وقمرها ونجومها وسحبها، مع الجمادات التي تُحيط بي، مع عائلتي وأصدقائي. واللذين ليس بالضرورة أن يصاحبوني في مشيي ويشاركوني النظر لنفس الطريق أو تأمل نفس السماء، بل في أحيانٍ كثيرة مشيت وأنا أهاتفهم، وأنا أفكر بهم، وكنت أعرف أنهم هم كذلك يمشون! مشيت مع أحلامي وهي في الخيال، وهي تتحول لأهداف، وهي تتنفذ، وبعد أن تحققت.
(أُحِب المشي معِك) .. ربما لأني عجزت عن المشي كما اعتدت لمدة طويلة.. كان واجباً على نفسي، بمجرد استعادة قدرتي على المشي أن أخبره إلى أي حدّ أحُبه، أن أكثِر من المشي معي! مع نفسي! أن أقطع كيلومترات كثيرة وأنا مركّزة معي وعليّ وبي. أن أحتفي بي بطيّ كل هذه المسافات نحوي، بالمشي على الأرض، والرمل، والعشب، والحجر، والألم.
كنت في بعض اللحظات أفكر ببعض الأفكار، التي كانت تذكرني على وجه التحديد بأحاديث وخطوات قطعتها وأنا أمشي بصحبة صديقاتي اللواتي مشيت معهم في كل أحوالي، حتى في الوقت الذي لم أكن به معي. كنت دائماً حين أمشي، أمسك بيد من أمشي معه وألعب بها بالهواء! لكن توقفت عن فعل هذا في زمنٍ ما، رغم أنّني أبقيت يدي ممدودة لمن يريد أن يمسك بها لأشد عليها في حال أمسك بها من أمشي معه. امتد هذا السلوك معي، من كونه مجرد يد ماديّة ممدودة بالهواء، لن تتردد بالشدّ على اليد التي تمسك بها. إلى يدي الشعورية! فقلبي كذلك لن يمسك بأي قلب يكفّ شعوره وحبه الصادق عنّي، ويقابل تواجدي وحضوري المشاعريّ التام معه بالجفاء والقسوة واللامبالاة.
لطالما ارتبط لديّ إمساك اليد أثناء المشي بمشاعر الطمأنينة والأمان، والسكينة، والثقة، والحب! كنت دائماً حين أخرج من المدرسة، أمسك بيد أبي رغم أن السيارة تبعد أقل من خمس عشرة متراً عن الباب، ولا يتطلب سيرنا قطع للشارع لأمسك به. ومع ذلك كان والدي حريص أن يبقيني في جهة الرصيف إن كان مزدحماً أو ضيّقاً أو محطّماً، ليمشي هو بالجانب الذي تمر بجانبه السيارات، مما عزز من مشاعر الحب والأمان والثقة والرعاية معه وبه.
حين كنت في الصف الأول الثانوي، كنت أمشي مع صديقتي وأنا ممسكة بيدها ورأتني إحدى المعلمات التي لم تكن تعرفني ولم تدرسني وقالت لي موبخة بنبرة بشعة متهّمة: “ليه ماسكة يدها؟ بتشرد يعني؟؟!!” تركت يدها إلى أن اختفت، ثم عدت لإمساكها مرة أخرى ونحن نضحك ونقول: “معلمة دين.. بس مخها منحرف”. فقدت صديقتي هذه بعد أسبوع من ذلك اليوم، وشعرت حينها أنّي فقدت جزء من يدي للأبد! ولم أمسك من بعد ذلك اليوم إلا بأيادي إخوتي مضطرّة حين أمشي معهم في السوق أو الشارع لحمايتهم والسيطرة على شقاوتهم.
حين كنت في التاسعة عشرة من عمري ذهبت لعيادة الأسنان، وخلعت ضرس أتعب الطبيب وأتعبني لشدة انغراسه في فكي. ظننت حينها أني كبيرة بما يكفي لأذهب وأعود من مشوار كهذا بمفردي! لكن بمجرد ما انتهيت اتصلت بوالدي وهو في عمله وقلت له: “أنا مرة دايخة من البنج وراسي ثقيل وأخاف يغمى علي! تعال لي!” لا أعرف كيف نجحت بالتحدث حينها لكن، خلال 10 دقائق بالضبط كان بجانبي! أمسك بيدي من غرفة الانتظار إلى أغلق باب السيارة، ثم عاد وأمسك بها طوال الطريق إلى أن وصلنا للمنزل. لم أنس ذلك اليوم أبداً، لأني تذكرت حينها شعور الطمأنينة والهدوء والسكينة والأمان والحب من خلال يده التي أحيت كل تلك المشاعر بي مجدداً.
في ذلك اليوم أدركت أني حين فقدتها لم أفقد جزء من يدي أبداً، وأني فقط استبدلت إمساك الأيادي بالنظر المفرط للسماء بحثاً عن كل ما كانت تبثه بي تلك اللمسات. وكأني كنت أحاول أن أجد طريقاً آخر أوصِل به مدى ثقتي وسعادتي وارتياحي مع من أمشي معه! ورغم أنها طريقة تعبير لا بأس بها، إلّا أنها لم تكن تملأ قلبي الشاسع أو تعبر عن كل ما أشعر به.
يوجد نوع من الصلة والمشاعر الصادقة، التي لن تشعر بها وبتجذرها وتغلغلها في روحك إلّا من خلال لمس اليد، ولأجل هذا كان اللمس أحد الحوّاس الخمسة. لن أتحدث عن الحواس ما فوق الخمسة مثل: الحدس وشم رائحة الكذب والخوف، معرفة ما يخفيه من تحب، معرفة شعور من يبعد عنك والإحساس به.. والكثير الذي يعجز عن استيعابه كل من يمنطق المشاعر! لكن هي أشياء سيأتي ما يثبتها في يومٍ ما. مثل ما أثبت اختراع عدسات المجاهر أن الأمراض تسببها ميكروبات لا ترى بالعين المجرّدة، لا الشياطين ولا الأرواح الشريرة.. ستثبت هي كذلك!

يقول العلم أنّ الإنسان يجدد ويغيّر جميع خلايا جسده كل سبعة أعوام، حيث أنّ هذا الرقم هو متوسط عمر الخلايا وقد يزيد أو ينقص من شخص لأخر ومن نوعٍ لآخر من الخلايا. أما أنا، فالله وحده من يعلم كم مرة انسلخت روحي وتجددت خلاياي منذ 22 يونيو 2020 إلى نهاية عام 2024.
لم أعد أؤمن بندرة واستحالة وجود طائر العنقاء، أظن أننا خُدعنا وصدّقنا فكرة أنه طائرٌ عملاق منقرض، ذو جناحين كبيرين ملتهبان بالنار. بينما هو مختبئ في داخل أجسادنا، جناحيه أقفاصنا الصدريّة، رأسه قلبنا، ويتقّد ويشتعل بحرارة دمائنا!
مشيت وأنا سعيدة وحزينة، بالصحة والمرض، بمفردي أو برفقة، متنزهة ومتأملة، هادئة وقلقة، رايقة وغاضبة، خائفة وآمنة، حائرة ومطمئنة، أثناء المذاكرة والقراءة، محدّقة بالسماء ومفكرة بالفراغ. لكن لأول مرة في العام الماضي أمشي بنيّة أن أخطو الخطوات تجاهي، لأعرف نفسي وأقترب منها أكثر من أي وقتِ مضى.
اعتدت دائماً أن أنشر تدوينة يوم ميلادي في صباح اليوم نفسه، لكن هذه المرة أنشرها في دقائقه الأولى لأني قررت أن أودع عامي الماضي كذلك بالمشي معي. لأختمه وأنا موقنة أن الطمأنينة والهدوء والسكينة والحب والأمان، هي بروحي وكياني وعينيّ وكل خلايا جسدي ليست فقط بيديّ! لأبدأ عامي الجديد بعد مشي طويل.. مشي استمر إلى ما لا نهاية ودون أيّ وجهة.. مشي انتهى بوصولي لشعوري أنني أخيراً 100% معي، ومع هذا لن أنتهي من المشي!
شعرت بلحظة الاكتمال هذه في ليلة يوم أربعاء، مشيت بها كثيراً إلى أن انتهيت جزئياً من المشي بالاسترخاء في مكانٍ وجدتني به تماماً. أصابتني في تلك اللحظة حالة خدر شديدة، من شدة السكون والسعادة والنشوة والهدوء، إلى حدّ أنّي لم أفهم ما كنت أعيشه وما كان يحدث معي حينها. كثافة المشاعر النقيّة والصافية التي اجتاحتني جعلتني أشعر بالتجذّر وسط كل ذلك الأوركيد الأبيض، والفل ورائحتهما العطرة التي ملأت أنفي. بقيت لساعات بمفردي أمشي أو بالأحرى أطوف ثم أعود وأجلس في نفس تلك البقعة. لم أستطع المغادرة ولم أستطع البقاء، ابتسمت لكرسيّ محدد وسط كل ذلك البياض غنيت له: ” لا قدرانة فل ولا قدرانة أبقى!” ودّعته بعد أن استنشقت رائحة المكان وقلت: “وعد.. سأعود.. وعد” وخرجت دون أن ألتفت وأنا موقنة أنّ ذلك المكان هو جنّتي في هذه الأرض.

حين مشيت اليوم وأنا أستحضر كل المشي الذي مشيته خلال هذا العام وأنا أطوي المسافة بيني وبيني.. تذكرت ذلك المساء وكل ذلك البياض فانتعشت ذاكرتي. الفلّ.. هي الزهرة الأولى التي ميّزت وعرفت رائحتها منذ طفولتي، والتي كان يقطفها لي أبي حين تزهر شجرتها، ويخبئها لي في جيبه بمنديل إلى أن يعود للمنزل ويعطيني وأختي وأمي الفُلّ الذي معه. ارتديت عقوده على عنقي ومعصمي في كل مرة رأيت بها بائعة ورد (حجّة) _بالمناسبة أين اختفوا هولاء الحجّات وعقودهم الزهيّة؟_ تبيعه بمفرده أو مزيّناً بالورد أو الفُلّ من يزيّن الورد.. لا أعلم من يزيّن الآخر! ما علينا.. أحب رائحته طازجاً ومجففاً ولا أطيق رائحته بعد أن يقطّر.. أو أن الذي شممته كان مغشوش بالكحول إلى ضاعت رائحته لا أعلم. أمّا زهرة الأوركيد.. فهي أنا! كنت قد أخبرتكم في تدوينة عيد ميلادي الثلاثين.. هذه هي إن لم تقرأوها: “أنني لو كنت زهرة سأكون أوركيدة بيضاء.. نقيّة ونبيلة”. في تلك المشية وسط ذلك الأوركيد ودّعت كل الشوائب، استعدت نقائي وتذكرت نبلي وأدركت إلى أي حدّ.. أحب المشي معي!
منذ عيد ميلادي العشرين وأنا أسمي كل عام بعنوان يوصفه، تجدون بعضها تحت تصنيف يوم الميلاد. اليوم أنهي عامي الماضي وأنا أضع فوقه تاج (أُحب المشي.. معِك). لكن لأول مرة أبدأ العام الجديد وبرفقتي عنوانه منذ اليوم الأول! سأشارككم به العام القادم أما الآن فهو لي وحدي.
اثنان وثلاثون صيفاً، ولا زلت أشعر في أيامٍ كثيرة أني أعيش صيفي الثالث! وهذا أمر جيّد لا أريد للطفلة التي بداخلي أن تشيخ، أو تهرم، فلتبقى هي وفضولها وخفّة روحها وحيويتها وقلبها الكبير أحياءًا للأبد.






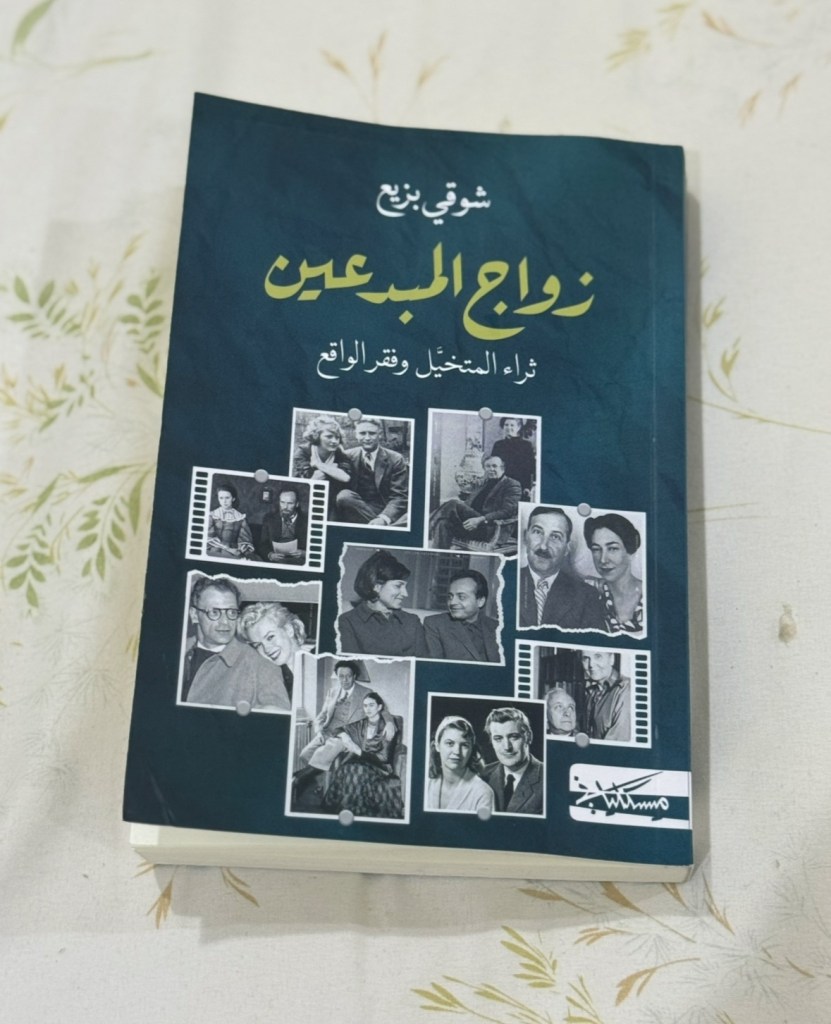


أضف تعليق